نحاور الروائي الجزائري بومدين بلكبير، المعروف برؤيته السردية المغايرة والمتجددة. حيث نسلط الضوء على روايته “ثلاث حيوات لرجل واحد”، المعروفة أيضًا بعنوان “زوج بغال”، وهي رواية تتقاطع فيها الحكاية الشخصية مع المأساة الجماعية، وتستعرض تشظي الإنسان بين ماضيه الثقيل وحاضره المأزوم. من خلال هذا الحوار، نحاول استكشاف خلفيات كتابة الرواية وأبعادها الرمزية، وأسباب اختيار هذا العنوان المزدوج، إضافة إلى التفاعل الذي لقيته الرواية في الجزائر وخارجها.
الهند أول بلد تترجم فيه روايتكم “ثلاث حيوات لرجل واحد” أو “زوج بغال” في إنجاز ثقافي غير مسبوق في الجزائر، يحمل دلالات متعددة. برأيكم، لماذا لاقت الرواية هذا الاهتمام تحديدًا في الهند؟ وهل تعتقدون أن القضايا الإنسانية التي تعالجها الرواية هي التي مكّنتها من تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية؟
وصول “ثلاث حيوات لرجل واحد” إلى القارئ الهندي لم يكن امرًا عشوائيًا أو مجرد فضول ادبى عابر، بل جاء من صميم الهمّ المشترك، إن صح التعبير. صحيح أن الرِّواية تنطلق من الجزائر، لكنها تتجاوز حدودها، لتروي قصة “إنسان الازمات”؛ عن مقاومته، وعن محاولته للنجاة او الخلاص الفردي من عبثية الزمن والسياسة والتاريخ. فالكتابة عن هذا الموضوع، هي صورة لتقاطعات القلق الإنساني العابر للجغرافيا والاثنيات، والتى تعد السياسة، أو بالأحرى أزماتها، من أبرز أسبابه، سواء عند الإنسان الهندي البسيط، أو الجزائري، أو المغربي، أو الصحراوي. او أماكن رسمت السياسة حدودها الجغرافية متناسية الروابط التاريخية والاجتماعية بين أفرادها.
فمعبر “واجا” بين الهند وباكستان، هو صورة أخرى لمعبر “العقيد لطفي/زوج بغال” بين الجزائر والمغرب، او المعابر بين الكوريتين او بين السودان وجنوب السودان… حيث هذه
المعابر المغلقة تصبح رمزًا لكل ما يكبّل الإنسان ويعزله قسرًا عن ذاكرته وعن الآخر، حتى وإن كان هذا الآخر هو الأخ او الأب أو الأم.

الرواية، من هذه المنظور، ليس ترفًا أو أداة لتجزية الوقت. إنها محاولة لإذابة جبل الجليد ولفتح معابر رمزية وإنسانية، حين توصد السياسة كل الأبواب. حين تُقرأ الرواية في دلهي أو اسلام أباد، كما تُقرأ في تلمسان أو وجدة، نكتشف أن الإنسان واحد، يحمل معاناة واحدة ووجع واحد، رغم الحدود.
صدرت الرواية في ظل ظروف حساسة بين الجزائر والمغرب، وكان من المتوقع أن تكون الرواية إيديولوجية، تميل الرواية لمحاكمة طرف دون آخر، كما تفعل أحيانًا وسائل الإعلام لدى كل طرف من شحن للمواقف، لكن الرواية جاءت بلغة العقل، تحاسب الطرفين دون حدة أو شجب مباشر. في هذا السياق، كيف ترى دور الأدب والثقافة في رأب الصدع بين الشعوب أو الدول؟ وهل تعتقد أن الكتابة يمكن أن تكون شكلاً من أشكال الدبلوماسية الناعمة؟
الأدب لا يُكتب تحت الطلب، أو رضوخا لإيديولوجيا سياسية، ولا يمكن حصره في إطار جغرافي ضيق، بل ينشأ في الهامش الإنساني العميق وهو فوق كل انتماء. فالرواية لا تشعل النعرات ولا تؤجج الصراعات، بل جاءت لمحاولة تفكيكها، وهذا هو دور الأدب، وهو أعمق من الأدوار الدبلوماسية: يُنصت لما لا يُقال، لما يختفي خلف الشعارات والصراعات، لما يتبقّى من الإنسان وسط الضجيج.
الرواية في جوهرها ليست نداءً للسلام والتأخي الإنساني فقط، بل هي استعادة للذاكرة، وإعادة تفكيك ما رسخته السرديات الرسمية من أحكام جاهزة. فالرواية قوة تخاطب الضمير الجمعي بدل حوار الطرشان، وتدعو للفهم بدل الاتهام، والتعاطف بدل الانفعال، وهذا من أرقى أشكال الدبلوماسية الناعمة، لا بمعناها السياسي أو الوظيفي.
حين نكتب عن صراع ما لا ننحاز إلا للحقيقة الإنسانية، لا نجامل أحدًا، إننا لا نكتب لنكون طرفًا في النزاع، بل لنفهم لماذا أصبحنا أطرافًا فيه.
في روايتك الأولى “خرافة الرجل القوي”، طرحتَ صراع المثقف مع السلطة من موقع الوعي والمعرفة، صراع قد يبدو مفهوم الأسباب. أما في ثلاث حيوات لرجل واحد او زوج بغال، فنُقل الصراع إلى الإنسان البسيط، الذي يعيشه دون أن يفهم أسبابه أو يملك أدوات التعبير عنه.
هل ترى أن البعد السياسي في الرواية يمكن أن يُروى من هامش التجربة لا من مركزها؟ وهل تختلف دلالة الصراع حين يُعبَّر عنه بلسان المثقف مقارنة بلسان الفرد العادي؟
في “خرافة الرجل القوي”، الصراع واضح، مباشر، يتخذ شكل مواجهة قد تنتهي بانكسار المثقف أو انسحابه من المشهد أو من الحياة ذاتها. أما في زوج بغال أو ثلاث حيوات لرجل واحد، فالصراع لا يُعلن عن نفسه. الإنسان البسيط لا يصطدم بالسلطة بوصفها خصمًا واضحًا، بل يعيش تحت أثرها كمن يعيش في ظلّ لا يعرف مصدره، يطلب شيئًا بسيطًا: أن يُترك لحياته، أن يمرّ بسلام.
سرد الهامش، بهذا المعنى، شكل آخر من المقاومة؛ مقاومة بلا شعارات، بل باللغة التي لا يسمعها المركز. فالمركز لا يعترف إلا بمن يتكلم بلسانه، ولا يرى إلا ما يعكس صورته.
الرواية ليست بيانًا سياسيًا، بل مرآة لِما تتركه السياسة من أثر على الناس وعلى الأحلام الصغيرة.
يتّسق عنوان الرواية بشكل لافت مع أحداثها، حيث يعكس بوضوح ليس فقط حالة الصراع بين طرفين او بلدين لا يُنصت أحدهما للآخر، بل صراع يمكن قراءته أيضا كثنائية بين الفرد والسلطة، يسير كل منهما في اتجاه مناقض للآخر، ما يعني أن العربة لن تتحرك أبدًا. في رأيك، ومن خلال ما تعكسه الرواية، كيف يؤثر غياب الحوار والتكامل بين المركز والهامش على مسيرة التقدم أو حتى على سيرورة الحياة؟
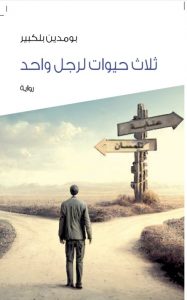
حين يغيب الحوار بين المركز والهامش او بين البلدين الجارين، لا نتوقف فقط عن التقدّم، بل يهدد ذلك شروط استقرار الحياة ككل، ويُجهِض فكرة الوجود ذاتها. غالبا ما يحوِّل الصراع والشد والجذب الواقع إلى ساحة حرب وقتال لا مشروع حياة مشترك. طرفان يشتركان في المصير ذاته، لكن يرفضان الاعتراف بذلك!
الهامش لا يطلب شيئًا أكثر من أن يُرى أو أن يُسمَع، لكن حين يُصمّ المركز أذنيه ويكتفي بفرض اتجاهه او منطقه، يفقد سلطته قوتها ويخلق ضدّه أعداء أو معارضة عميقة. وقد ينسحب الهامش ويختار الصمت أو التهكّم من الواقع المفروض، هذا الخلل البنيوي لا يُعطّل السلطة فحسب، بل يُفكك منظومتها من داخلها، ببطء ولكن بثبات.
الهوية والاغتراب الاجتماعي هما من أبرز محاور الرواية، حيث نرى البطل يتنقّل بين عوالم متعددة، ليس فقط جغرافيًا بل أيضًا اجتماعيًا -وهي عوالم متشابهة في الظاهر، لكن لا يكمل بعضها بعض، فاصبح عاجزا عن وجود بيئة حاضنة له. برأيك، هل أزمة الهوية التي يعيشها البطل كمثال على انسان اليوم تنبع أساسًا من أزمة فكرية داخلية، أم أنها نتيجة لإكراهات الواقع وظروفه الضاغطة؟
سؤال الهوية، في نظري، لا يُفهم من خلال ثنائية الداخل والخارج، أو الأنا والآخر، بل في تلك المسافة المربكة بينهما، حيث لا يكون الانتماء ممكنًا، ولا القطيعة مكتملة. فالبطل لا يُعاني من واقع يرفضه فحسب، بل من وعي لا يعثر على ما يُشبهه. عوالمه متشابهة في ظاهرها، لكنها عاجزة عن احتوائه، لأن اغترابه ليس مكانيًا، بل وجوديًا.
لذلك، أزمة الهوية في الرواية ليست خيارًا فرديًا ولا مجرّد نتيجة لإكراهات الواقع، بل حصار داخلي في فضاء لا يُتيح إمكانيّة العيش المشترك، ولا يعترف بشرعيّة الاختلاف. هي غربة لا عن المكان، بل عن الوعي.
قلنا إن السياسة تُعد المحرك الأساسي لكثير من أزمات اليوم، وفي الرواية وردت بعض صور هذه الأزمة مثل الفساد الإداري والإقصاء، التهميش وغير ذلك من الظواهر السلبية. في رأيك، كيف يمكن مقاربة هذه القضايا من خلال الرواية ثقافيًا؟ هل أصبحت الرواية نوعا من التوثيق، أم ترى أن لها دورًا أعمق يتجاوز السرد إلى اقتراح حلول أو صياغة بدائل فكرية؟ وهل ترى في الكتابة خطة مقاومة ثقافية؟
الرواية لا تُصلح العالم، لكنها تكشف علله. حين تكتب عن الفساد أو التهميش أو الإقصاء، فأنت لا توثّق فحسب، بل تُعيد ترتيب الوعي المخدر المعتاد على قبول الواقع كما هو.
أنا لا أؤمن بأن على الرواية أن تقترح حلولًا؛ هذا شأن السياسة. لكن الرواية قادرة على تفكيك المسلّمات التي تتشكل منها الأزمة، وعلى استنطاق التجربة من داخلها، لا من ظاهرها. وهذا بذاته شكل من أشكال المقاومة: مقاومة النسيان، والتسطيح، والتكرار العقيم.
الكتابة، بهذا المعنى، ليست ترفًا جماليًا كما سبق وذكرنا، بل فعل ثقافي مُضاد، يعيد تشكيل الوعي الجمعي تجاه الخضوع والتسليم بالأمر الواقع. وحين تنجح الرواية في ذلك، فهي لا تغيّر الواقع مباشرة، لكنها تغيّر الطريقة التي نراه بها، وذلك أصل كل تحوّل إيجابي.
في روايتك يظهر عبد القادر كشخص بسيط، ليس مثقفًا أو صاحب نفوذ، لكنه يشعر أن مصيره مرتبط بما يحدث في محيطه؛ يتفاعل مع البيئات المختلفة بوعي داخلي، لا بسذاجة. كيف عالجت الصورة النمطية للفرد البسيط الذي يُعتقد غالبًا أنه ساذج أو غير واعٍ، بينما هو في الحقيقة يحمل إدراكًا سياسيًا أو إنسانيًا عميقًا رغم كل شيء؟
طبعا، تحاول الرواية تفكيك الصورة النمطية للفرد البسيط؛ خاصة تلك الكليشيهات الجاهزة على أنه هامشي أو ساذج، ولم يتلقى تعليمًا عاليًا. صحيح، عبد القادر، في ظاهره، ليس مثقفًا، رجلا أنهكته الحياة وعواقبها، لكنه يمتلك الوعي اللازم المتراكم من التجارب، وعي يُترجم في حدسه، وفي مواقفه.
هذا النوع من الوعي لا يحتاج لغة نُخَبَويّة متعالية، بل يحتاج فقط أن ننصت له. فعبد القادر يتحرك بوحي من إحساس داخلي عميق، حتى لو لم يستطع أن يعبّر عن ذلك بخطاب سياسي. وهذا ما حاولت أن أبرزه خلال اشتغالي على الرواية، فالفهم ليس حكرًا على المتعلمين، وأن الإنسان البسيط ليس فارغًا أو تافها، بل ممتلئ بتجارب وخبرات تراكمية تعطيه مستوى من الحكمة والقيمة.
يُعاب على شخصية عبد القادر في الرواية أنه كثيرًا ما يتصرف بعشوائية وتهور، وكأنه يسير بلا خطة واضحة. في رأيك، ما أهمية وجود خطة أو أهداف مرسومة في حياة الإنسان؟ وهل ترى أن غياب هذه الرؤية هو أحد الأسباب الجوهرية لتأخر الفرد أو حتى فشله أحيانًا؟ وهل قصدت من خلال عبد القادر أن تعكس نوعًا من التيه العام الذي يعيشه الإنسان البسيط في واقع مأزوم؟
صحيح، تظهر الرواية كيف أن عبد القادر لا يعيش فقط بلا خطة، بل بلا أفق واضح أيضًا. لكنه لا يفعل ذلك من باب اللامبالاة او الترف أو الاختيار الواعي، بل لأنه يعيش في بيئة لا تؤمن بثقافة التخطيط للمستقبل، ولا بإمكانية التحكم في المصير الفردي في مجتمعات مأزومة ومقهورة، يكون الضياع والتحرك خبط عشواء هو القاعدة، لا الاستثناء. غياب الأهداف ليس فقط فشلاً ذاتيًا، بل انعكاس لعجز بنيوي أكثر تعقيدا؛ غموض المستقبل، ضعف التعليم، ومشكلة الهوية.
جسّدت شخصية عبد القادر هذا التيه والضياع، ليس بوصفه سلوكًا فرديًا منعزلا، بل كصورة لشرائح واسعة من الناس الذين تحوّلت حياتهم إلى مجرد ردود أفعال ترقيعية، لا إلى سلوكات وأفعال مرسومة مسبقا. لا تدين الرواية، عبد القادر، بل تحاول كشف السياق الذي كرّس العشوائية. كثيرًا ما نُحمّل الأفراد مسؤولية فشلهم، لكن قليلا ما نتأمل ما دفعهم للضياع. يمكن القول ان اللامبالاة والعشوائية ليست فقط مجرد سلوك عابر وعفوي، بقدر ما هي موقف أو شكل من أشكال المقاومة الصامتة أحيانًا.
يبدو عبد القادر الرگراگي، رغم كونه ضحية لتهميش اجتماعي وسياسي، عاجزًا عن ممارسة الحد الأدنى من الحوار داخل بيته، خاصة مع زوجته، وكأن ما مورس عليه من إقصاء أعاد إنتاجه بدوره على محيطه الصغير. هل ترى أن القمع، بوصفه بنية ذهنية وسلوكية، لا يُفرض من الأعلى فقط بل يُعاد إنتاجه أفقيًا داخل العلاقات اليومية؟ وهل ترى أن غياب ثقافة الحوار في الطفولة وفي الأسرة ساهم في تطبيع الاستبداد السياسي لاحقًا؟ بمعنى آخر: هل تبدأ السلطة من البيت؟
أتفق معك تمامًا؛ فالقمع ليس فقط ما يُمارَس علينا من سلطة أعلى منا، بل هو ما نحمله معنا او داخلنا ونمارسه بدورنا، أحيانًا دون وعي، على من هم حولنا. عبد القادر الرگراگي ليس مجرد ضحية، بل أيضًا ناقل للعدوى. فكل مهزوم يحمل في داخله احتمالية أن يصير جلاّدًا صغيرًا، لا بالسوط بل بالصمت، بالتجاهل، بالإقصاء والإيذاء العاطفي.
السلطة تبدأ من البيت، من لحظة لا يُسمح فيها لطفل بطرح سؤال، من امرأة لا يُسمع لرأيها، من أب يتكلم ولا أحد يجرأ على مقاطعته أبدا. هذه السلوكات اليومية تشكل نواة الاستبداد السياسي لاحقًا، لأنها تُطبِّع الإنسان على الامتثال والخضوع أو على ممارسة الاستبداد والتسلط على الآخرين متى ما أُتيحت له فرصة الهيمنة. روايتي لم تكن فقط عن رجل مهمَّش، بل عن كيفية تحوُّل هذا الإهمال والتهميش إلى آلية تهميش أخرى. عندما يغيب الحوار في الأسرة، أو مع أقرب المقربين، فكيف نطالب به في الفضاء العام!؟
نود العودة إلى مسألة تأثير السياسة في رواية “ثلاث حيوات لرجل واحد”، لكن من زاوية معكوسة: هل فعلاً السياسة هي التي أفسدت سلوك الأفراد، أم أن المشكلة أعمق، في بنية المجتمع نفسه، الذي قد يكون ‘فاسد’ من الأساس؟ هذا المنطلق مهد لكتابة روايتك “زنقة الطليان” فيما بعد، هل يمكن القول إن “زنقة الطليان” لم تنطلق فقط من فكرة نقد السياسي، بل من محاولة لقراءة مجتمع موسّع يعيش خللاً أخلاقيًا وسلوكيًا أعمق؟ وهل جاءتك فكرة الرواية من هذا التشظي الاجتماعي قبل أن يكون سياسيًا؟
السياسة ليست قوة بمعزل عن المجتمع، بل هي مظهر من مظاهره. فهي تولد من المجتمع وهو يمارس سلطته على نفسه. حين يعيش الناس في مجتمعات حيث يتم تنشئتهم على الصمت، ويعتبر الخضوع قيمة أخلاقية واجتماعية، لا يمكن أن ننتج إلا نسخًا ونماذج سياسية مشوّهة تتوالد من هذا القمع اليومي الممارس في بيئاتهم المعتلة. فالمشكلة لا تبدأ في مؤسسات الدولة، بل في الأب الذي لا يصغي، في الزوج الذي يصدر الأوامر، في الطفل الذي يُمنع من السؤال. من هنا، كانت فكرة كتابة زنقة الطليان، لم تكن فقط عن مجتمع خاضع، بل عن مجتمع يُعيد إنتاج خضوعه بشكل شبه طوعي. لم أكتب عن السياسة، بل عن هشاشة الفرد داخل منظومات أوسع وأكبر منه، تبدأ من البيت ولا تنتهي في البرلمان. المجتمع، حين لا يملك أدوات مساءلة ذاته، يُفوّض السياسة لتكون مرآة لتوحّشه المقنّع.
يُعتبر عملك بمثابة سابقة في الأدب الجزائري، سواء من حيث البيئة التي تدور فيها الأحداث أو من حيث القضية التي طرحتها، وحتى طريقة التناول، و بالتالي يمكننا الحديث عن كسر او تجاوز لكثير من كلاسيكيات الكتابة الروائية في الجزائر تحديدا . هل الامر من باب التجديد الفني او القضية هي من فرضت عليك تجديد آليات الخطاب بمعنى آخر هل هي رؤية خاصة تقول بضرورة تجربة افكار غير السياسيين لحل المشاكل؟ متى يكون الكاتب جراحا؟
في الحقيقة، لم أسعَ إلى كسر قواعد الكتابة السائدة على أساس احدث ثورة في الشكل أو من باب احداث فرق او فارق. وجدت أن الموضوع غير قابل لأن يُروى بالطرق الكلاسيكية؛ فالأمر لا ينجح عندما يكون الواقع متشظيا، إذ تصبح الأساليب القديمة غير صالحة تمامًا. مهم جدا أن يبحث الروائي عن شكل يستوعب هذا العالم المشوش، المهمل، والمنسي. لهذا في طريقة تناولي للموضوع، لم تكن اختياراتي التقنية عبثية، فضرورة كسر الزمن، والتاريخانية، وكسر بنية الكتابة لكي أتمكن من قول حقيقة لا يمكن تُقال إلا بهذه الطريقة.
لا أبحث في رواياتي عن بدائل سياسية بقدر ما أحاول طرح الأسئلة.
هل الكاتب يمكن أن يصبح طبيبا أو جرّاحًا؟ حين يضع مشرط الكلمات ويكشف موقع العلة، فالكتابة، في هذا السياق، ليست إصلاحًا، بل كشفا وتعرية للخراب والبشاعة المخفية بالأقنعة وبعمليات الليفتينغ الإيديولوجية.
تناولت الموضوع بقدر كبير من الحياد. برأيك، ما الذي يحتاجه الكاتب ليحافظ على هذا الحياد؟ وأقصد هنا تحديدًا العوامل الذاتية: كيف يتعامل الكاتب مع قناعاته، مشاعره، وربما حتى انحيازاته الشخصية أثناء الكتابة؟
الحياد في الرواية، هو الانحياز لصالح الحقيقة؛ حقيقة التعدد، والتناقض الإنساني. الكاتب لا يكتب عن ما يؤمن به فقط، بل يكتب أيضًا ما يخيفه، وما يُخالفه.
وفي سبيل ذلك، يحتاج الكاتب إلى انضباط والتزام داخلي صارم؛ أن يتحكم في مشاعره دون أن يتحول إلى ناطق رسمي باسم الشخصيات في الرواية، مهم جدًا أن يسيطر على تسرب قناعاته ورؤيته الذاتية داخل نصوصه السردية. الكتابة، في هذه الحالة، تصبح تمرينًا على الصدق مع الذات قبل الآخر، وانصافا أيضا للذات والآخر المختلف. وليس الحياد بمعناه البارد.
فالروائي لا يُقدّم خطابًا ضيقا ورؤية قاصرة عن قناعاته، بل يُنصت للصوت الآخر، وفي هذه الحالة من التصالح، يصبح الحياد فعل شجاعة.

